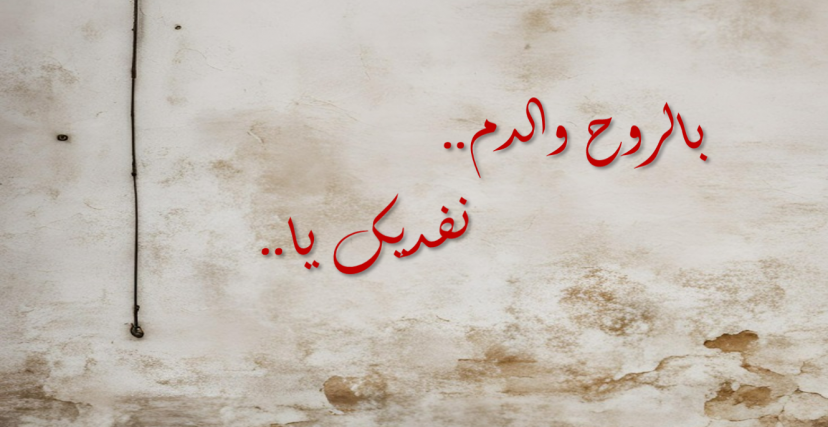من "الحُڨرَة" إلى "الحرقة".. قراءة في كتاب "مدن العبور في تونس"
صدر منذ أيام قليلة عن المفكرة القانونية كتاب جماعي من 114 صفحة حول مسألة الهجرة غير النظامية حمل عنوان "مدن العبور في تونس تأثير سياسة الحدود في المجتمع والاقتصاد"، من خلال أمثلة من المدن التونسية الساحلية التي تعتبر منطلقات تقليدية لهذا النوع من الهجرة، وهي على التوالي جرجيس وصفاقس وجبنيانة والشابة وقليبية. لا يتعلق الأمر إذًا بأهم المدن الساحلية وإنما بأكثرها مساهمة في الهجرة غير النظامية، ما يتطلب حدًا أدنى من المُداراة والتخفي الذين لا تمنحهما المدن المينائية الكبرى، بالرغم من أن هذه الأخيرة تساهم، وإن كان بنسبة أقل، في تيار الهجرة.
كتاب جماعي حول مسألة الهجرة غير النظامية صدر مؤخرًا واحتوى على خمسة فصول قام بتحريرها باحثون شبان من مجالات مختلفة ومثّل ورقات ذات قيمة علمية هامة
بالإضافة إلى النص التقديمي الذي حرره الصحفي ياسين النابلي باعتباره مشرفًا على المشروع، فقد احتوى الكتاب على خمسة فصول، اهتم كل منها بإحدى المدن المذكورة سابقًا، قام بتحريرها باحثون شبان من مجالات بحثية مختلفة كعلم الاجتماع والعلوم السياسية، وهم على التوالي خالد الطبابي ومحمد رامي عبد المولى وحمادي لسود وخليل العربي وأحمد جماعة.
لكن هناك ميزة أخرى لهذه الورقات، وهي أن محرريها كانوا في الغالب من أبناء المدن التي وقع الاشتغال عليها، ما يضيف إلى البحث العلمي خاصية المعرفة بالميدان، وهذا من حيث المبدأ توجه متميز لا يمكن إلا أن ينتج ورقات ذات قيمة علمية هامة.
ينبغي أن نلاحظ في البداية أن مصطلح "الهجرة غير النظامية" أصبح هو السائد حاليًا بالمقارنة مع المصطلح القديم والذي كان نابعًا من المؤسسات الرسمية إلى حد قريب، وهو مصطلح "الهجرة غير الشرعية". هناك بين التسميتين مسافة طويلة من الجدل، ومن عمل منظمات المجتمع المدني التي استطاعت تقديم مصطلح أكثر موضوعية عن ذلك الذي كانت السلطات تسعى لفرضه.
في الجانب الآخر من الحدود، فإن الأوروبيين يميلون إلى استعمال مصطلح "الهجرة غير القانونية". ما هو غير قانوني يصبح بهذا المعنى سريًا، أي ممنوعًا، هذا المصطلح مجرد نموذج عن الحماس الذي طالما حدا السلطات الرسمية التونسية للاستجابة للطلبات الأوروبية، ذلك الحماس الذي نشأ منذ نشأة هذه الظاهرة، أي منذ شيد الأوروبيون فضاء "شينغان"، وأغلقوا القارة على القادمين من الجنوب.
يركز كتاب "مدن العبور في تونس تأثير سياسة الحدود في المجتمع والاقتصاد" على حقيقة أن فضاء "شينغان" هو الذي أنتج الهجرة غير النظامية، إذ لم تكن موجودة قبله، وكان الناس يتنقلون بصفة طبيعية بين الضفتين
يركز الكتاب على هذه الحقيقة: شينغان هي التي أنتجت الهجرة غير النظامية، إذ لم تكن موجودة قبلها، وكان الناس يتنقلون بصفة طبيعية بين الضفتين. لاعتبارات النمو والسيادة غير المتكافئين، ظلت السلع تنتقل من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال، ولكن في المقابل مُنع سكان الضفة الجنوبية من هذا الامتياز، ففرضت التأشيرات التي لم تلبث أن وقع تضييق شروط الحصول عليها لتصبح بالتدريج أداة ضغط على دول الجنوب للحصول على مكاسب سياسية.
ما يطرحه الكتاب بطريقة شديدة الوضوح هو تحليل اقتصاد الهجرة غير النظامية، حيث يتتبع مؤلفوه هذا الاقتصاد من المنبع إلى نقطة الوصول، متسللين من خلال ذلك إلى إدراك طبيعة الاعتبارات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية التي جعلت من تفاعل الدول، شمالاً وجنوبًا، مع هذه الممارسة مؤشرًا لمستوى تمتعها بالسيادة، ومقياسًا لقدرتها على خدمة مصالح اقتصادياتها وتمثيل انتظارات شعوبها. وبالفعل، وإن لم ننكر الجوانب الثقافية والسياسية والنفسية، فإن الاقتصاد يفسر ليس فقط نشأة هذه الظاهرة، وإنما تحولاتها والوضع الذي انتهت إليه اليوم.
تعاني النماذج المدروسة من التلوث البحري، أو من بعض انعكاسات ظاهرة الاحتباس الحراري، ما أدى ضرورة إلى تناقص أهمية نشاط الصيد البحري، وتضرر الغراسات وكل النشاط الفلاحي، وبالتالي انهيار المداخيل المتأتية من هذا النشاط التقليدي، مع نفور متزايد من الأجيال الشابة للانخراط في هذا الاقتصاد المأزوم.
في الوقت نفسه، لم تعمل الدولة على بناء أي بدائل تنموية تُعوّض الخسارة في نشاط الصيد أو الزراعة. وإذا ما استثنينا بعض النشاط السياحي هنا وهناك، فقد دخلت هذه المدن شيئًا فشيئًا في أزمة هيكلية جسمها ارتفاع نسب البطالة والفقر بين سكانها بما يتجاوز المعدلات الوطنية.
ما يطرحه الكتاب بطريقة شديدة الوضوح هو تحليل اقتصاد الهجرة غير النظامية، حيث يتتبع مؤلفوه هذا الاقتصاد من المنبع إلى نقطة الوصول وبالفعل فإن الاقتصاد يفسر ليس فقط نشأة هذه الظاهرة وإنما تحولاتها
بطريقة أو بأخرى، فإن الخبرة في الإبحار التي راكمتها أجيال صيادي الأسماك كان ينبغي أن يقع تصريفها، فتحولت هذه الخبرة إذًا إلى معرفة مطروحة للبيع، أو لأن يقع استغلالها بطريقة أخرى لفائدة أبناء البحار أو أقاربه أو أصدقائه، عندما أغلق الأوروبيون طرق الهجرة التقليدية المعمول بها منذ آلاف السنين بين الضفتين. هل كان هناك من حل آخر أمام هؤلاء من أجل البقاء؟ لأن القضية قد أصبحت في نهاية الأمر قضية صراع من أجل البقاء، في معناه الأكثر غريزية.
أمام قصور سياسات التنمية وفشلها، ترك هذا النشاط لينمو شيئًا فشيئًا تحت أنظار السلطات لفترة ما، ثم فهمت هذه السلطات أن بإمكانها، هي أيضًا، الاستفادة منه. هنا ستبدأ مرحلة أخرى، ستنطلق من منتصف التسعينيات، عندما ستعمل الحكومة التونسية على بيع خدماتها في مراقبة هذه الهجرة للأوروبيين، مقابل مكاسب سياسية ومالية. لم يتغير الأمر كثيراً منذ ذلك الوقت حيث تواصل الدولة هذا النشاط المربح إلى اليوم عبر الاتفاق الأخير مع الاتحاد الأوروبي والذي ترعاه إيطاليا.
تتشكل حول الهجرة غير النظامية شبكة كاملة من الأنشطة والممارسات، حيث يصبح العمل الهش في الأشغال المرهقة سبيلاً أساسيًا لتوفير ثمن "الحرقة"، أي اجتياز الحدود البحرية خلسة. تنشأ بالموازاة مع ذلك وظائف وأنشطة متكاملة: نجد في أعلى الهرم منظم الرحلة، وأدنى منه صاحب "الشقف"، وذلك الذي يوفر المحرك، وذلك الذي يقوم بتجميع المرشحين للعبور وإيوائهم في انتظار موعد الرحلة، وذلك الذي يوفر المحروقات، والميكانيكي الذي لا بد منه في كل رحلة بسبب الأعطال المتوقعة في المحرك. يضاف إلى ذلك فيما بعد الأسرة، التي تقوم بتجميع ثمن الرحلة رغبة منها في رؤية ابنها يغادر البلاد أخيرًا من أجل فرصة بناء مستقبله، وربما بعض أعوان الدولة لغض النظر.
تجد هذه الشبكة في مواجهتها شبكة أخرى، رسمية، متكاملة وعابرة بدورها للحدود: قوانين تسلط أكبر العقوبات تحت غطاء "مكافحة الاتجار بالبشر"، تعاون مع الأوروبيين بالأموال والوسائل لمراقبة البحر بشكل أفضل، دوريات أمنية تتكثف يومًا بعد يوم في مدن العبور، أسطول من السفن الحربية في المياه بين القارتين، مراقبة بالأقمار الصناعية والطائرات المأهولة والمسيرة، إلى آخر ذلك من احتياجات نظام عسكرة الحدود.
لم ينه ذلك الهجرة غير النظامية ولم يوقف رغبة الشباب، بل والعائلات في السنوات الأخيرة، في المغادرة. ما حصل فقط هو تحول المتوسط إلى مقبرة تقتات من المجازر التي تقام على نخب الباحثين عن شيء يشبه المستقبل على الضفة الأخرى. ليس أبلغ من ذلك الدعاء الذي ينطق به منظم رحلة على مركب معدني تجاه الركاب: "ربي يرحمكم"، "ليس الموجع ما قيل، لكن الأكثر إيلامًا أن الحارقين كانوا يردون مبتسمين. مبتسمين للموت المحتم". لقد كانوا في عداد الموتى حتى قبل أن ينطلق بهم المركب المنكوب.
كان اقتصاد "الحرقة" قائمًا ومزدهرًا حتى قبل قدوم المهاجرين من مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء، كل ما تغير هو زيادة حجم هذا الاقتصاد، وبالتالي زيادة التحديات المرتبطة به
كان اقتصاد "الحرقة" قائمًا ومزدهرًا إذًا حتى قبل قدوم المهاجرين من مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء. كل ما تغير هو زيادة حجم هذا الاقتصاد، وبالتالي زيادة التحديات المرتبطة به: احتياطات أكبر لإنجاح عمليات العبور، مصاريف أعلى، مراقبة أكبر من أجهزة الدولة، ضغوط أكثر من الاتحاد الأوروبي، عسكرة أضخم للحدود في المتوسط، بل وعلى الحدود البرية للبلاد، من حيث يتسرب المهاجرون.
في نهاية الأمر، فإن العوامل التي تدفع بالتونسيين إلى الرغبة في المغادرة هي نفسها التي أتت بمواطني دول جنوب الصحراء إلى تونس، وإلى مدن العبور تحديدًا. ليس في الأمر أي مؤامرة لمن ألقى السمع وهو شهيد. هل ورطتنا أوروبا في مهمة أكبر من حجمنا وقدراتنا، في مقابل فتات مساعدات؟ في الحقيقة لم تكن المساعدات كل شيء، حيث أن المساندة السياسية لمنظومة الحكم التي تركزت بداية من 25 جويلية/يوليو 2021 وتبييضها أوروبيًا كانت المكسب الأكبر من المعاهدات التي أمضيت للقضاء على الهجرة غير النظامية.
مع ذلك، فقد تورطنا بالتأكيد: مصادمات بين الأهالي التونسيين والمرشحين للهجرة من أفارقة جنوب الصحراء الذين يتجمعون في مدن العبور الهشة أساسًا اقتصاديًا واجتماعيًا، عدم القدرة على ضبط كامل للحدود البرية التي يتسللون منها، عدم القدرة على توقيع اتفاقيات ترحلهم لبلدانهم، إلخ. لقد أصبحت تونس بالفعل مصيدة تتضخم يومًا بعد يوم بالضحايا: ضحايا غرق المراكب في البحر، ضحايا الاتفاقيات الذين يستجلبون من أعالي البحار لإلقائهم مجددًا بمدن العبور، عدم القدرة على إنهاء التوترات بينهم وبين التونسيين في هذه المدن بسبب غياب سياسات حقيقية، زيادة هشاشة هذه المدن، وإنفاق أموال المساعدات الأوروبية للمزيد من إتقان دور حارس الحدود عوض إنفاقها لتحسين ظروف الحياة للمرشحين للهجرة. دائرة مفرغة لا خروج منها لأحد، خاصة عندما تعتقد الدولة أن الأمر مجرد "مؤامرة" عليها، وعندما تتراجع اعتبارات السيادة أمام ثرثرة لا نهاية لها.
إن العوامل التي تدفع بالتونسيين إلى الرغبة في المغادرة هي نفسها التي أتت بمواطني دول جنوب الصحراء إلى تونس، وإلى مدن العبور تحديدًا، ليس في الأمر أي مؤامرة
يحسن الكتاب في المحصلة الربط بين مفردتين، مصطلحين، كثيري التواتر في الفضاء التونسي: "الحرقة" (أي الهجرة غير النظامية) و"الحُڨرَة" (أي التهميش). ما تقوله الورقات التي أثثت هذا الكتاب أضحى الآن معروفًا، إلا من طرف الدولة: الحُڨرَة تدفع نحو الحرقة. ليست الحُڨرَة سوى غياب الكرامة، وغياب العدالة الاجتماعية، وغياب المحتاجين عن سياسات الدولة ومن اهتماماتها. احتراق جيل كامل، بل أجيال متلاحقة، من الشبان، الذين كان أخطر ما فقدوه ليس مواطن الشغل، بل الأمل في أن يجدوا مستقبلاً لهم في تونس في يوم من الأيام.
هذا اليأس هو الذي يدفع "بالحارق" إلى إلقاء نفسه في البحر رغم إدراكه بأن فرص غرقه وانتهائه في بطون الأسماك أكبر بكثير من فرص وصوله إلى الضفة الأخرى. لا تختلف الحرقة في معناها كثيرًا عن عملية إضرام النار في الجسد، لا لغة ولا مجازًا.
يأخذ الكتاب قضية الهجرة غير النظامية من قضية إنسانية وأخلاقية إلى قضية جيوستراتيجية واقتصادية واجتماعية متشابكة العناصر، ولكن متناسقة في الفهم الذي يقع إتقان تناوله عبر فصوله الخمسة
في المقابل، حُڨرَة مزدوجة، من دولة تلعب دور حارس الحدود المتحمس لأسباب تتعلق بها فحسب، ومن فضاء يعتبر المهاجرين مجرد أشياء تافهة وليس بشرًا قادمين من بلاد طالما وقع تفقيرها ونهب ثرواتها تحت الاستعمار وبعده إلى اليوم. لا يختلف الأمر مطلقًا بالنسبة لمهاجري جنوب الصحراء الذين ألقت بهم صدف الجغرافيا بيننا، بالرغم من كل المحاولات الرسمية والمتحمسة أيضًا لحرف القضية عن مضمونها الحقيقي.
يأخذ الكتاب قضية الهجرة غير النظامية من قضية إنسانية وأخلاقية إلى قضية جيوستراتيجية واقتصادية واجتماعية متشابكة العناصر، ولكن متناسقة في الفهم الذي يقع إتقان تناوله عبر فصوله الخمسة. من خلال بورتريهات هذه المدن يقدم الكتاب تحليلاً للفشل الجماعي في تونس: الفشل في إنجاز التنمية، وفي الإقناع بوعودها، والفشل في تحقيق شيء ما يمكن أن يشبه السيادة.