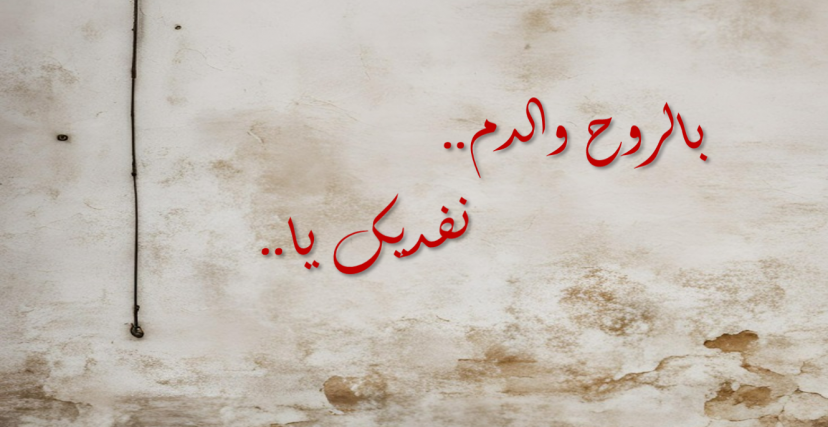التونسيون وأحداث سوريا.. حكماء الخيبة
فيما عدا عدد محدود من التونسيين، فإن الانطباع المسيطر هو أن أغلبهم لا يبدو متحمسًا لما حصل ويحصل في سوريا منذ أسبوعين. صحيح أن هؤلاء يقدمون في الغالب قراءات عن الوضع هناك تبرر غياب ذلك الحماس، وهي قراءات تعطي الأولوية للتفسير في سياق الحرب على غزة وعلى لبنان، لكن تقديري أن مردّ غياب الحماس لا ينطلق مما عاشته وتعيشه سوريا، بقدر ما أن مردّه هو ما عاشته تونس بالذات.
هناك، بغض النظر عن سوريا، تقييم قاس لما حصل في تونس منذ أربعة عشر عامًا. ذلك ما يجعل الناس فيها اليوم حكماء أكثر من غيرهم. ربما تشابه رد فعلهم هنا مع ردود فعل المصريين، ولكن اهتمامي سيتركز هنا على التونسيين.
التونسيون يريدون أن يحقق السوريون ما عجزوا هم عن تحقيقه، ويرون أنه من الأفضل أن يتم ذلك بسرعة وتحضّر
ما الذي عاشته تونس وأدى إلى هذا اليأس الحكيم؟ أشياء كثيرة، أولها أنّ التونسيين تعلموا أن كل شيء يظهر في البداية رومانسيًا، لكنه لا ينفك يتحول شيئًا فشيئًا إلى كابوس، حتى إنّ الأمور تكون قادرة على العودة، تقريبًا، إلى ما كانت عليه. لنكن عادلين: جزء هام من هؤلاء الحكماء كان متحمسًا بقوة للثورة السورية في بداياتها، وظل كذلك إلى بدايات تحولها إلى نوع من الحرب الأهلية. كانوا، وإن أقرّوا باليأس من إمكانية محافظتها على سلميتها في مواجهة نظام بمثل تلك الدموية، يريدونها أن تبقى كذلك.
بطبيعة الحال، في دولة مثل سوريا، حيث واجه النظام المظاهرات بالدبابات والطائرات، لم يكن ممكنًا ألا تتحول الثورة إلى حرب أهلية. التونسيون مسالمون في معظمهم، وغير متعودين على رؤية الدماء تسيل بكثرة، وفي ظل تعقيدات المشهد السوري والتدخلات النشطة للأطراف الإقليمية والدولية، بل وفي ظل اكتساب عديد المجموعات المقاتلة هناك إما وجهًا طائفيًا أو وجهًا إرهابيًا، وتمثيلها لمصالح دول قريبة أو بعيدة، فإنهم أهملوا موضوع سوريا تمامًا. لقد تحول إلى موضوع صعب الفهم بالنسبة إليهم، لكن ما جعلهم يهملونه هو طابعه الدموي المكثف، وليس تعقيداته.
لا تُخفي حكمة التونسيين إزاء ما يحصل في سوريا، سوى خيبتهم من الثورة التي قاموا بها، ومن الجنة التي فقدوا القدرة على بنائها
في خضم تطورات المشهد الميداني في سوريا منذ تحوّل الثورة إلى طابعها المسلح الذي أدى، بعد تحولات معقدة ودامية، للوضع الذي نراه اليوم، لم يكن نادرًا في السنوات الماضية أن تستمع لأنصار الثورة في تونس يعبرون عن نوع من الشعور بالذنب: لقد ثار السوريون تلبية لنداء انطلق في البداية من تونس، بما يعني، وهذا ندم مغلف بالغرور التونسي الأصيل طبعًا، أننا جنينا عليهم.
هناك "سندروم" تونسي يجعل أهل هذه البلاد مقتنعين بأنهم مركز الكون، بل وأنهم المثل الذي يَحتذي به فعلًا الآخرون، أو يجب عليهم أن يحتذوا به. جذور هذا "السندروم" عميقة، وهو نفس "السندروم" الذي يعتقد المصابون به، على كثرتهم، بأن على السوريين اليوم أن يستمعوا إليهم، وأن يستفيدوا من تجربتهم.
قل لهم إنه لا تشابه بين التجربتين إلا في أهدافهما النظرية الرومانسية العالية، وسيأخذون الأمر فقط من زاوية أنه يريح ضمائرهم بعض الشيء. أصلًا، لماذا يرهق التونسيين ضمائرهم وترهقهم؟ هل يشبه ما يحدث في سوريا اليوم ومنذ عشر سنوات، ما حصل عندنا؟ إذًا فلمَ القلق؟ سيتبع كل شعب ما قدّر له في النهاية، وهذا القدر سيكون بالتأكيد خليطًا بين ما أراده هو وما أراده له الآخرون. نسب الخلطة فقط هي التي ستكون مختلفة من بلد إلى آخر، بحسب سياقها وتجانس رغبات أبنائها.
ما الذي عاشته تونس وأدى إلى هذا اليأس الحكيم؟ أشياء كثيرة، أولها أنّ التونسيين تعلموا أن كل شيء يظهر في البداية رومانسيًا، لكنه لا ينفك يتحول شيئًا فشيئًا إلى كابوس، حتى إنّ الأمور تكون قادرة على العودة، تقريبًا، إلى ما كانت عليه
ما الذي يريده التونسيون؟ ثورة لا يشتم منها رائحة أجانب، يسقط فيها النظام باللافتات والشعارات والقبضات المرفوعة في المظاهرات، ثم ينسحب أعوان وأنصار النظام القديم جميعًا إلى بيوتهم، فلا تسمع عنهم بعد ذلك خبرًا، وينشأ نظام جديد يحقق لهم كل انتظاراتهم دفعة واحدة وبسرعة، وألا تكون خلافات أو صراعات مهما كان نوعها وحجمها، وإن وُجدت فإنها تحل بالنقاش الهادئ المتحضر. لا أحد يمكن أن يشك في حسن نوايا التونسيين إذن، من حيث المبدأ. المشكل الوحيد هو أنهم يريدون أن يحقق السوريون ما عجزوا هم عن تحقيقه بهذه الطريقة، وأنه من الأفضل أن يتم ذلك بسرعة وتحضر.
لا تخفي حكمة التونسيين في النهاية سوى خيبتهم من الثورة التي قاموا بها، ومن الجنة التي فقدوا القدرة على بنائها، ومن كل الأساليب التي جربوها من أجل انتصار رومانسيتهم المخترقة للزمن وللجغرافيا. يتعاطفون جدًا مع مشاهد المساجين الذين يتم تحريرهم، والعائلات التي تبحث بلا جدوى عن بقايا لأبنائها في معتقلات التعذيب الرهيبة. تنتابهم، في غمرة هذا التعاطف الجيّاش، رغبة في القول إننا "كنّا مثلهم"، ثم يتذكّرون بأن عدد المساجين الذين أطلقت السلطات سراحهم يوم 14 جانفي/يناير، كان يعد على أصابع اليد الواحدة، وأنهم كانوا، تقريبًا، معززين مكرمين، إذا ما قارنّاهم بغيرهم ممن نرى وجوههم اليوم يخرجون من صيدنايا وغيرها.
إذا كنا في تونس قدّمنا الدليل على العجز عن حل خلافات بسيطة، فكيف نتوقع أن تتم الأمور في سوريا حيث تكمن الاعتبارات الطائفية المعقدة في زاوية كل شارع وركن كل بيت؟
نعيش في الواقع تناقضات عديدة ومكثفة: إذا كانت رومانسيتنا في تونس هي من جنت علينا، فكيف نريد أن تتم الأمور في سوريا بطريقة رومانسية؟ وإذا كان مردّ خوفنا مما يحصل هو من جهة انعكاساته على المقاومة في لبنان وغزة، فكيف يكون استعباد وإبادة شعب، طريقًا لإنقاذ شعب آخر من الاستعباد والإبادة؟ وإذا كنا في تونس قدّمنا الدليل على العجز عن حل خلافات بسيطة وعدنا مثل حليمة إلى كل عاداتنا القديمة، فكيف نتوقع أن تتم الأمور في سوريا حيث تكمن الاعتبارات الطائفية المعقدة في زاوية كل شارع وركن كل بيت؟ وإذا كنا نحن مقسمين بهذه الحدة، ومنذ أربعة عشر عامًا، بين "العربية" و"الجزيرة"، فكيف نستغرب أن تكون سوريا منقسمة بين كل الدول القريبة والبعيدة؟ وإذا كنا ذلك البلد الصغير في أقصى الخارطة الذي يعجز عن إزعاج أحد حتى لو أراد، والذي تدخلت في مسار ثورته رغم ذلك كل تلك الدول، صغيرها وكبيرها، فكيف تكون سوريا الغنية والكبيرة، والتي تقع على مرمى حجر من كل صراعات العالم؟
حكمتنا المبالغ فيها اليوم تجاه ما يحصل في سوريا، هي حكمة الخائبين الذين توفر لهم كل شيء، وفشلوا رغم ذلك في كل شيء. لا دخل لسوريا بالأمر بتاتًا. نصف هذه الحكمة المتأخرة فقط كان سينقذنا من الخيبة، ولكنه مجرد استيقاظ متأخر لمشاعر رقيقة.